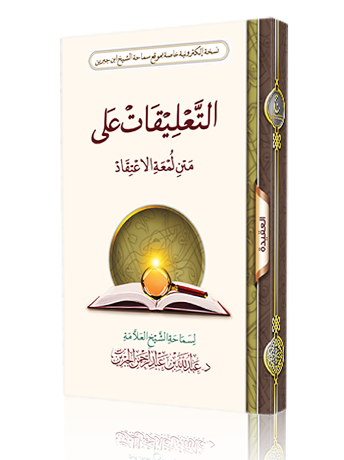الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

مسألة: بعض آيات صفة النفس والمجيء والإتيان
وقوله:
( وقوله تعالى إخبارًا عن عيسى عليه السلام أنه قال:  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ  [المائدة:116] وقوله تعالى:
[المائدة:116] وقوله تعالى:  وَجَاءَ رَبُّكَ
وَجَاءَ رَبُّكَ  [الفجر:22] وقوله تعالى:
[الفجر:22] وقوله تعالى:  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ  [البقرة:210] . )
[البقرة:210] . )
شرح:
قوله:
 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ  فيها إثبات النفس لله تعالى، والنفس حقًّا تطلق على الذات، قال الله تعالى:
فيها إثبات النفس لله تعالى، والنفس حقًّا تطلق على الذات، قال الله تعالى:  كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ  ( الأنعام:54 ) ( على نفسه ) يعني: على ذاته، وتقول: جاءني فلان نفسه، يعني: تأكيدًا حتى لا يُتوهم أنه جاءك رسوله أو ابنه، فإثبات النفس على أنها الذات معروف، ويمكن القول بأن قصد عيسى عليه السلام في قوله:
( الأنعام:54 ) ( على نفسه ) يعني: على ذاته، وتقول: جاءني فلان نفسه، يعني: تأكيدًا حتى لا يُتوهم أنه جاءك رسوله أو ابنه، فإثبات النفس على أنها الذات معروف، ويمكن القول بأن قصد عيسى عليه السلام في قوله:  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي  ما في ضميري؛ ما أُسِرّه في نفسي وما أخفيه في قلبي، وما لا أتكلم به بل أحدث به نفسي خفية في قلبي،
ما في ضميري؛ ما أُسِرّه في نفسي وما أخفيه في قلبي، وما لا أتكلم به بل أحدث به نفسي خفية في قلبي،  وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ  .
. وبكل حال؛ هذا دليل على إثبات هذه الصفة، وإذا أطلقت النفس على الذات، أو أطلقت على ما في النفس يعني ما هو خفي، وما يضمره الإنسان، أو يخفيه الرب تعالى كان هذا سائغًا، وكان دليلا واضحًا على إثبات هذه الصفة.
وقد تأولها كثير من المنكرين، وأنكروا إطلاق النفس على الله تعالى، مع أنها أطلقت في القرآن في هذه الآيات وما أشبهها، وكذلك في بعض الأحاديث، ولكن لا عبرة بهم ولا بتأويلاتهم، فنحن نتقبلها، ونكل كيفيتها إلى خالقها، هذا إثبات صفة النفس.
أما الآية التي بعدها: إثبات صفة المجيء
 وَجَاءَ رَبُّكَ
وَجَاءَ رَبُّكَ  ( الفجر:22 ) وكذلك قوله تعالى:
( الفجر:22 ) وكذلك قوله تعالى:  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ  ( البقرة:210 ) ومثلها قوله تعالى:
( البقرة:210 ) ومثلها قوله تعالى:  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ  ( الأنعام: 158 ) .
( الأنعام: 158 ) . هذه الآيات مما حصل فيها اختلاف كثير وإنكار كبير للمتأخرين من المتكلمين و بالغوا في تأويلها وتحريفها عن ظاهرها، فتجدهم ينكرون صفتي المجيء والإتيان ونحو ذلك، بل قرأت في تفسير بعض المعتزلة أو الأشاعرة - لمَّا أتى على الآية من سورة البقرة:
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ  قال: وأما إتيان الله؛ فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء والذهاب لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات هكذا علل منزه عن المجيء والذهاب.
قال: وأما إتيان الله؛ فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء والذهاب لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات هكذا علل منزه عن المجيء والذهاب. وسمعت من حكى مناظرة جرت بين سُنِّي وبين مبتدع؛ فقال المبتدع: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقال السني: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، فجعلوا المجيء والذهاب من صفات المحدثات والمركبات - كما يقولون - ونزهوا الرب عن أمثال هذا، وجعلوا النزول والمجيء والإتيان الذي ذكره الله - تعالى - أنه زوال عن مكانه وحركة، وجعلوا هذا تشبيهًا لمجيء المخلوق وانتقاله وما أشبه ذلك، ولكن لا إنكار في شيء من ذلك؛ فالأحاديث والآيات صريحة واضحة وليس لنا أن نتدخل في تأويلها، ونسعى في تحريفها.
ثم إن المتأخرين من المتكلمين يقولون في آيات المجيء والإتيان إن فيها قولين:
القول الأول: ينسبونه للسلف، وهو أنهم يعتقدون أن السلف يسكتون ولا يعتقدون فيها مجيئًا حقيقيًّا بل يسكتون عنها، ويتركون الكلام فيها، ويمرونها دون أن يتكلموا فيها أو يفسروها بأي نوع من أنواع التفسير، وإنما يسكتون عنها دون الخوض فيها، ويقولون: لا تأويل لها ولا تفسير لها ولا نخوض فيها، ولا نتكلم فيها، ولا ندري ما معناها، ولا نبحث في دلالتها، هكذا يزعمون أن السلف على هذه الطريقة.
والقول الثاني: تأويلهم لها بأنواع من التأويلات المتكلفة، وأكثرهم على أن فيها مقدرًا تقديره: جاء أمر ربك، أو يأتيهم الله، أي: أمر الله
 أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ
أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ  ( الأنعام:158 ) أي: أمر ربك، وكان من جملتهم زاهد الكوثري الذي حقق كثيرًا من الكتب وأفسدها، فمن جملة ما حققه كتاب ( الأسماء والصفات ) للبيهقي، فإنه أفسده بتعليقاته عليه، ولما أتى على هذه الآية قال: إن الله يقول في سورة النحل:
( الأنعام:158 ) أي: أمر ربك، وكان من جملتهم زاهد الكوثري الذي حقق كثيرًا من الكتب وأفسدها، فمن جملة ما حققه كتاب ( الأسماء والصفات ) للبيهقي، فإنه أفسده بتعليقاته عليه، ولما أتى على هذه الآية قال: إن الله يقول في سورة النحل:  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ  ( النحل:33 ) قال: ما دام في سورة النحل ( أو يأتي أمر ربك ) فإنا نقول كذلك في سورة البقرة
( النحل:33 ) قال: ما دام في سورة النحل ( أو يأتي أمر ربك ) فإنا نقول كذلك في سورة البقرة  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ  ( البقرة:210 ) أي: أمر الله، وكذلك آية الأنعام
( البقرة:210 ) أي: أمر الله، وكذلك آية الأنعام  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ  أي: أمره؛ وكذلك في سورة الفجر
أي: أمره؛ وكذلك في سورة الفجر  وَجَاءَ رَبُّكَ
وَجَاءَ رَبُّكَ  ( الفجر:22 ) أي: جاء أمره فجعل هذا محمولا على الآية التي في سورة النحل، وقال: إن القرآن يفسر بعضه بعضًا, ونحن نقول: لا يلزم من إتيان أمر الله في آية سورة النحل عدم إتيانه تعالى في آية أخرى، وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا يجيء كما يشاء، والأحاديث التي في الشفاعة فيها؛ أن بني آدم يطلبون الشفاعة ليأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بأنه إذا طلبت منه الشفاعة جاء، فإذا رأى ربه سجد، وأطال السجود، فيقول الله تعالى له:
( الفجر:22 ) أي: جاء أمره فجعل هذا محمولا على الآية التي في سورة النحل، وقال: إن القرآن يفسر بعضه بعضًا, ونحن نقول: لا يلزم من إتيان أمر الله في آية سورة النحل عدم إتيانه تعالى في آية أخرى، وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا يجيء كما يشاء، والأحاديث التي في الشفاعة فيها؛ أن بني آدم يطلبون الشفاعة ليأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بأنه إذا طلبت منه الشفاعة جاء، فإذا رأى ربه سجد، وأطال السجود، فيقول الله تعالى له:  ارفع رأسك، وسل تُعْطَه، واشفع تُشَفَّع
ارفع رأسك، وسل تُعْطَه، واشفع تُشَفَّع  الحديث
الحديث  , وذلك دليل على أن الله - تعالى - يجيء لفصل القضاء مجيئًا يليق بجلاله، ولا يلزم من ذلك تشبيه بالمحدثات والمركبات، فنعتقد هذه الصفة، ولا نقيسها على إتيان مخلوقاته، بل يأتي الله - تعالى - ويجيء كما يشاء، ويفصل بين عباده، ولا ينافي ذلك عظمته وجلاله وكبرياءه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، وما ذاك إلا أنا لا نحيط به علمًا، ولا نكيفه، ولا نكيف أية صفة هو عليها، هذا هو القول الحق, وأما الآيات التي فيها إتيان أمر الله كقوله تعالى:
, وذلك دليل على أن الله - تعالى - يجيء لفصل القضاء مجيئًا يليق بجلاله، ولا يلزم من ذلك تشبيه بالمحدثات والمركبات، فنعتقد هذه الصفة، ولا نقيسها على إتيان مخلوقاته، بل يأتي الله - تعالى - ويجيء كما يشاء، ويفصل بين عباده، ولا ينافي ذلك عظمته وجلاله وكبرياءه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، وما ذاك إلا أنا لا نحيط به علمًا، ولا نكيفه، ولا نكيف أية صفة هو عليها، هذا هو القول الحق, وأما الآيات التي فيها إتيان أمر الله كقوله تعالى:  فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا
فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا  ( الحشر:2 ) فالمراد: أتاهم الله بعذابه؛ وذلك لأنه معروف أن الله أرسل إليهم عذابًا؛ وهو الرعب الذي قذفه في قلوبهم، قال تعالى:
( الحشر:2 ) فالمراد: أتاهم الله بعذابه؛ وذلك لأنه معروف أن الله أرسل إليهم عذابًا؛ وهو الرعب الذي قذفه في قلوبهم، قال تعالى:  وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ  ( الحشر:2 ) .
( الحشر:2 ) . 
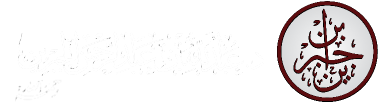







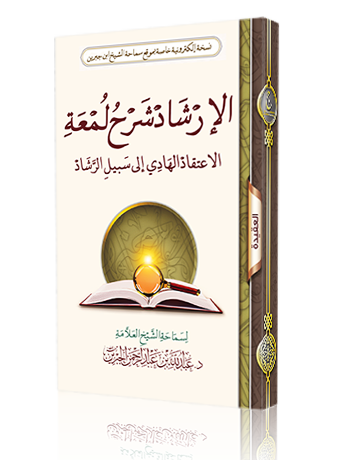
 مقدمة الطبعة الأولى للمؤلف
مقدمة الطبعة الأولى للمؤلف