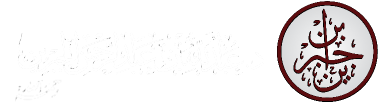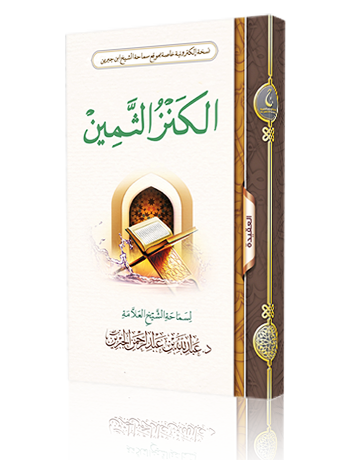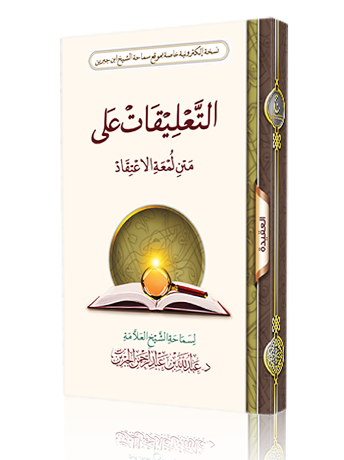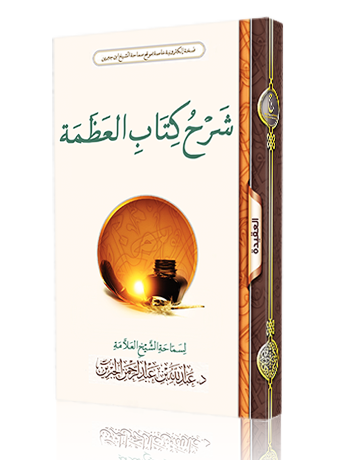الكنز الثمين

التوجه إلى الله والانقطاع إليه
ثم قال الكاتب:
[الصوفي: هو من عرف أن التوجه إلى الله والانقطاع إليه مما ينيل القصد، ويهيئ النفس للملكية.. إلخ].
أقول:
قد ذكرنا أول الكلام تعريف الصوفية في أول الأمر، ثم ما آل إليه أمرهم وما دخل عليهم من البدع، ثم الطرق التي أوقعت الكثير منهم في الخروج عن الإسلام: كالحلول، والاتحاد، فأما التوجه إلى الله والانقطاع إليه فهو صفة شريفة عَليَّة متى قصد منها الإقبال على العبادات، والتفرغ لها، والإعراض عن كل ما يشغل عن الطاعة، ويعوق عن مواصلة السير إلى الله.
وهذه طريقة أهل الزهد، والعلم، والعبادة من الصوفية السلفيين، ومن غير الصوفية، ولم يزل في المسلمين قديما وحديثا خلق كثير وجمع غفير يشتغلون جُلّ وقتهم بالعبادة القلبية الروحية، ويتوجهون إلى ربهم بقلوبهم، ويعلقون عليه آمالهم، وينقطعون إليه وحده، ويعرضون عما سواه، ولا ينافي ذلك إعطاء النفوس حظها من راحة، ولذة مباحة: من مأكل، ومشرب، ومنكح، وملبس، وكذا الاشتغال بالكسب الحلال، وجمع المال الذي تمس إليه الحاجة من وجوهه الجائزة، كما أمر الله بذلك في قوله:  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  . وكما في قوله تعالى:
. وكما في قوله تعالى:  وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  .
.
وإذا كان الأنبياء والرسل يلتمسون الرزق ويطلبون المال من وجوهه، كما قال تعالى:  وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ  . فكيف بأتباعهم ومن هو دونهم؟! فإن أراد الكاتب بالانقطاع إلى الله، ترك الدنيا وما فيها، والزهد في المباحات، والرهبنة، وترك كل الملذات ومشتهيات النفس التي تتقوى بها على الطاعات، فهذا الوصف والقصد غير صحيح، بل هو خلاف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسائر الرسل وأتباعهم.
. فكيف بأتباعهم ومن هو دونهم؟! فإن أراد الكاتب بالانقطاع إلى الله، ترك الدنيا وما فيها، والزهد في المباحات، والرهبنة، وترك كل الملذات ومشتهيات النفس التي تتقوى بها على الطاعات، فهذا الوصف والقصد غير صحيح، بل هو خلاف سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسائر الرسل وأتباعهم.
فأما قول الكاتب: [ويهيئ النفس للملكية].. إلخ. فهو خطأ من القول، فإن أراد بالملكية الصعود بالنفس إلى مقام الملائكة، واتصافها بالروحية والنورانية، والاتصال بالملأ الأعلى ونحو ذلك، فلا يصح، فإن نفس الإنسان لا تصل إلى صفات الملائكة التي من خصائصها: العلو، والخفة، والنور، والمكاشفات، والاستغناء عن الدنيا، والانكفاف عن الشهوات ونحوها، فإن الله ركَّب في طباع البشر من الشهوة، والالتذاذ بالمطعم والمشرب، والميل إلى ذلك، والتألم بفقده ما لم يكن من صفات الملائكة.
أما إن أراد بالملكية التملك وأن النفس تتهيأ لأن تملك شيئا من أمر الكون أو تدبره، أو تتصرف فيه تصرف المالك، فهذا أيضا لا يصح، فالنفس البشرية، وسائر النفوس المخلوقة ليس لها من الأمر شيء، ولا تقدر على التصرف المستقبل، ولا الملكية التامة النافذة، بل إن المخلوق نفسه مملوك لربه، ولو ملك الدنيا بأسرها، فملكه مؤقت وناقص، وهو وما بيده ملك لربه، فكيف يقال: إن انقطاع الصوفي ينيله القصد ويهيئ نفسه للملكية.