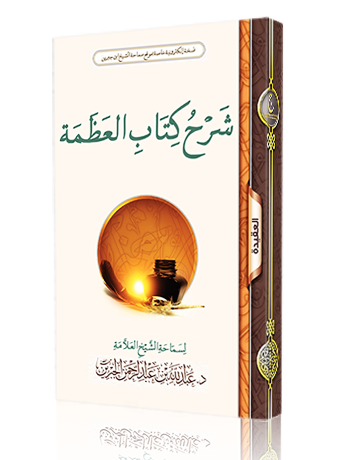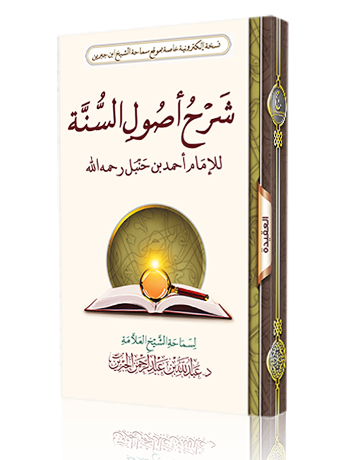التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية الجزء الثاني

إثبات صفة الاستواء على العرش وصفة علو الله على خلقه ومعيته لخلقه ووجوب الإيمان بذلك وأنه لا تنافي بينها
[ فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة؛ من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه، عَلِيٌّ على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون؛ كما جمع بين ذلك في قوله:  هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  [ الحديد: 4 ].
[ الحديد: 4 ].
وليس معنى قوله: ( وَهُوَ مَعَكُم ) أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء ، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان.
وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليه... إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله- من أنه فوق العرش وأنه معنا- حق على حقيقته ، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة؛ مثل أن يظن أن ظاهر قوله: (في السماء) ؛ أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ؛ فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ] .
ومما يتعلق بصفات الله وبالإيمان بالله، الإيمان بأنه تعالى هو العَلِيُّ الأعلى بجميع أنواع العلو، وأنه سبحانه على عرشه فوق سمواته، وفوق عباده
وكما أخبر بذلك في قوله :
 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ  [الأنعام : 18] ووصف نفسه بالعلو في قوله:
[الأنعام : 18] ووصف نفسه بالعلو في قوله:  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى  [الأعلى:1 ]
[الأعلى:1 ]  وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  [ البقرة :255 ] فيؤمن أهل السنة بعلو الله تعالى ، أنه عَلِيٌّ قهرًا أي عال عليهم قاهر لهم ، وعَلِيٌّ قدرًا : أي قدره أعلى من قدر المخلوقات ، وعَلِيٌّ بالذات : أي هو فوقهم بذاته.
[ البقرة :255 ] فيؤمن أهل السنة بعلو الله تعالى ، أنه عَلِيٌّ قهرًا أي عال عليهم قاهر لهم ، وعَلِيٌّ قدرًا : أي قدره أعلى من قدر المخلوقات ، وعَلِيٌّ بالذات : أي هو فوقهم بذاته. ثم يؤمنون- أيضا مع إيمانهم بأنه فوقهم فوقية حقيقية- بقربه وأنه لا ينافي علوه وفوقيته قربه ومعيته، بل هو قريب من عباده، كما في قوله تعالى:
 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ  [البقرة: 186 ] فنؤمن بفوقيته وعلوه، ونؤمن بمعيته وقربه، ونؤمن بأن هذا لا ينافي هذا.
[البقرة: 186 ] فنؤمن بفوقيته وعلوه، ونؤمن بمعيته وقربه، ونؤمن بأن هذا لا ينافي هذا. وجمع الله بينهما في هذه الآية في سورة الحديد حيث يقول تعالى:
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  [الحديد: 4 ] هذا هو العلو، فالاستواء هو العلو.
[الحديد: 4 ] هذا هو العلو، فالاستواء هو العلو.  يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ  [ الحديد: 4] هذا هو القرب، يعني هو معكم، مطلع عليكم، عالم بكم، مُراقب لكم، يراكم ويسمعكم، ولا تخفى عليه منكم خافية، فهذا هو القرب والمعية، جمع الله بينهما في هذه الآية.
[ الحديد: 4] هذا هو القرب، يعني هو معكم، مطلع عليكم، عالم بكم، مُراقب لكم، يراكم ويسمعكم، ولا تخفى عليه منكم خافية، فهذا هو القرب والمعية، جمع الله بينهما في هذه الآية. * وقوله: (وليس معنى قوله:
 وَهُوَ مَعَكُمْ
وَهُوَ مَعَكُمْ  أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق): أي أن قوله :
أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق): أي أن قوله :  وَهُوَ مَعَكُمْ
وَهُوَ مَعَكُمْ  ليس معناه أن الله مختلط بالخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا:
ليس معناه أن الله مختلط بالخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: والمعية كما تقدم قسمان:
الأولى: معية علم واطلاع وهيمنة ومراقبة، فهذه معية عامة.
الثانية: معية حماية وحفظ وكلاءة، فهذه معية خاصة.
وقد ذكر الله الأولى في هذه الآية :
 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ  [ الحديد: 4] وفي قوله:
[ الحديد: 4] وفي قوله:  وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ  [ النساء: 108] وفي قوله:
[ النساء: 108] وفي قوله:  وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ
وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ  [ المجادلة: 7 ] هذه المعية العامة التي مقتضاها العلم والاطلاع.
[ المجادلة: 7 ] هذه المعية العامة التي مقتضاها العلم والاطلاع. وذكر الخاصة في قوله تعالى:
 وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  [ العنكبوت: 69 ] وفي قوله :
[ العنكبوت: 69 ] وفي قوله :  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ  [ النحل: 128] وقوله:
[ النحل: 128] وقوله:  إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى
إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى  [ طه: 46 ] وقوله:
[ طه: 46 ] وقوله:  إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا  [ التوبة: 40] ونحو ذلك.
[ التوبة: 40] ونحو ذلك. فنؤمن بأن الله مع كونه عليا فوق عباده ، فإنه يراهم ويطلع عليهم، ولا تخفى عليه منهم خافية، ولا نقول: إنه مختلط بهم، وإنه في كل مكان بذاته، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ونحو ذلك، فإن هذا خلاف ما تقتضيه اللغة.
فالمعية لا تستلزم هذا، وهو أيضًا خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، فالخلق فطروا على أن ربهم من فوقهم:
 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ  [ النحل: 50 ] فكل مسلم إذا دعا الله فإن قلبه يتوجه إلى فوق، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، وذلك دليل على أن هذه فطرة لا يستطيعون مخالفتها.
[ النحل: 50 ] فكل مسلم إذا دعا الله فإن قلبه يتوجه إلى فوق، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، وذلك دليل على أن هذه فطرة لا يستطيعون مخالفتها. * وقوله: (بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن مطلع عليهم...):
ضرب المصنف رحمه الله مثلا بالقمر؛ لبيان علو الله على خلقه ومعيته لهم؛ فالقمر آية من آيات الله، وهو من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، معلوم أن القمر مُركب في فلكه، ولكن كونه معهم أي أنهم يرونه ويسيرون في ضوئه وفي نوره، فكأنه معهم، فالله تعالى مطلع على عباده، فهو معهم بعلمه وباطلاعه وبهيمنته وبرؤيته، وإن كان فوقهم بذاته.
فهذه الآيات تجرى على ظواهرها، وتُصان عن الظنون الكاذبة مثل ظن الظان أن قوله:
 وَهُوَ مَعَكُمْ
وَهُوَ مَعَكُمْ  [ الحديد: 4] أنه مختلط بالخلق، أو ظن قوله تعالى:
[ الحديد: 4] أنه مختلط بالخلق، أو ظن قوله تعالى:  أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ  [الملك: 16 ] أن السماء تظله فتكون كالظل عليه، أو تقله يعني تحمله فيكون معتمدًا على شيء من مخلوقاته أو محتاجًا إليه، والله تعالى غني عن ذلك، هذا ظن خاطئ بل معنى قوله: ( في السماء ) أي فوق السماء، أو أنه في جهة العلو كما يشاء، فهو غني عن العرش وعما دون العرش وعن السماوات كلها، وهو الذي يمسكها، يقول الله تعالى:
[الملك: 16 ] أن السماء تظله فتكون كالظل عليه، أو تقله يعني تحمله فيكون معتمدًا على شيء من مخلوقاته أو محتاجًا إليه، والله تعالى غني عن ذلك، هذا ظن خاطئ بل معنى قوله: ( في السماء ) أي فوق السماء، أو أنه في جهة العلو كما يشاء، فهو غني عن العرش وعما دون العرش وعن السماوات كلها، وهو الذي يمسكها، يقول الله تعالى:  إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ
إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ  [فاطر: 41 ] لولا إمساك الله تعالى لهذه السماوات ولهذه الأرض ولهذه الأفلاك لاضطربت وزالت، قال الله تعالى:
[فاطر: 41 ] لولا إمساك الله تعالى لهذه السماوات ولهذه الأرض ولهذه الأفلاك لاضطربت وزالت، قال الله تعالى:  وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ  [الحج: 165 ] فيمسكها أن تقع على الأرض إلا إذا شاء.
[الحج: 165 ] فيمسكها أن تقع على الأرض إلا إذا شاء. وقال تعالى:
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ  [ الروم: 25 ] يعني من آياته كونها مستمسكة قائمة، كل في فلك يسبحون، ليس فيها اضطراب ولا اختلاف؛ ذلك من آيات الله الكونية، فكيف مع ذلك يكون محتاجًا إلى شيء من مخلوقاته، أو أن شيئا منها يحمله أو يُقله أو يُظله أو ما أشبه ذلك.
[ الروم: 25 ] يعني من آياته كونها مستمسكة قائمة، كل في فلك يسبحون، ليس فيها اضطراب ولا اختلاف؛ ذلك من آيات الله الكونية، فكيف مع ذلك يكون محتاجًا إلى شيء من مخلوقاته، أو أن شيئا منها يحمله أو يُقله أو يُظله أو ما أشبه ذلك. فإذن نحن نعلم أنه تعالى فوق سمواته، وأنه مع ذلك مطلع على خلقه، مهيمن عليهم، مراقب لهم، قريب منهم، لا تخفى عليه منهم خافية؛ وذلك لأنهم خلقه، وجميع المخلوقات كلها حقيرة وصغيرة بالنسبة إلى عظمته، وهو يقبض السماوات كما يشاء،
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ  [ الزمر: 67 ] يقول ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم
[ الزمر: 67 ] يقول ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ![أخرجه الطبري في تفسيره عند قول الله تعالى: </رسم> وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ </رسم> <Taya> [ سورة الزمر، الآية: 67] </Taya> رقم (30212).](/site/books.png) .
. فإذا كان هذا مقدار هذه المخلوقات، دل ذلك على عظمة الخالق فكيف يكون محتاجا إلى هذه الأفلاك، أو أنها تحمله أو تقله أو تظله؟!.
فالحاصل أننا نؤمن بعلو الله، وبفوقيته، وبعظمته أينما كان، وباستغنائه عن العرش وعما دون العرش، والعبد إذا آمن بعظمة الله وقدرته وعلوه وفوقيته أورثه ذلك فائدة عظيمة وهي تعظيمه والخوف منه، فإنه متى عظم قدر ربه في قلبه خافه أشد الخوف، وراقبه واستحضر أنه يراه في كل وقت، فحمى نفسه عن أن يقدم على معصيته؛ لأنه يراه، فيقول: كيف أقدم على معصيته وهو يراني؟ كيف أترك ما نهاني عنه ؟ كيف أترك ما أمرني به؟ هذا من ثمرات الإيمان بهذه الصفات.

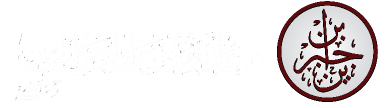








 سنة رسول الله...
سنة رسول الله...