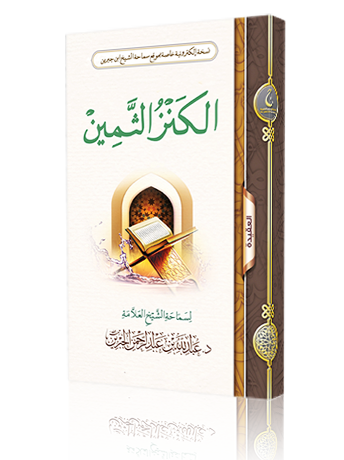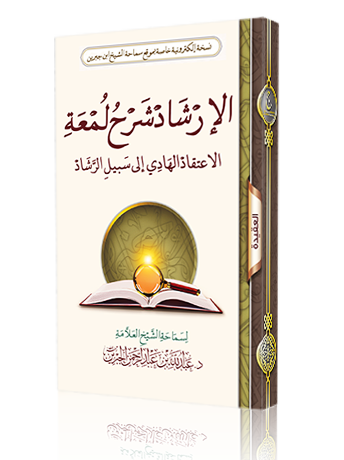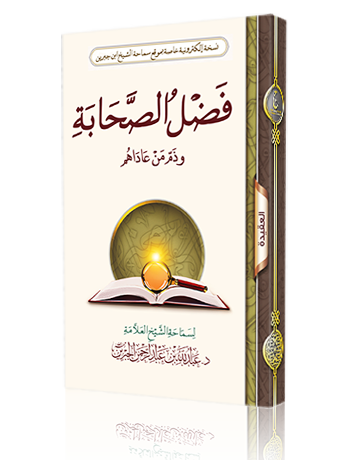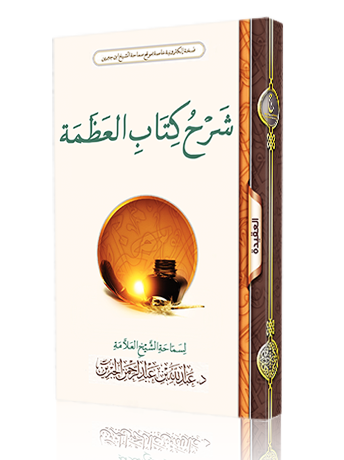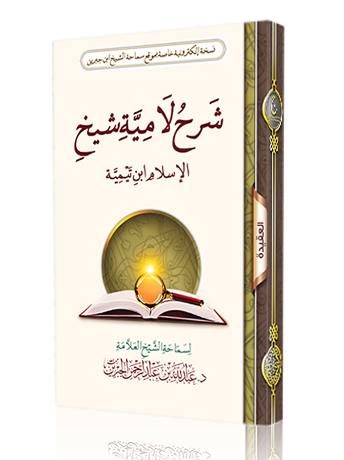الكنز الثمين

الرسل جميعا لم يخرجوا عن طبيعة البشر
ثانيا : الرسل جميعا لم يخرجوا عن طبيعة البشر .
ثم قال الكاتب في السطر الثالث عشر من الصفحة الثالثة:
[ومن أسف أن الوهابية قالوا: تمجيد الرسول بما يخرجه عن طبيعته البشرية باطل وزور… إلخ].
جوابه أن يقال:
مراده بالوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن انتفع بدعوته السلفية -رحمهم الله- وقد علم أنه -رحمه الله- لم يأت بجديد، وإنما جدد للناس ما اندرس من معالم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؛ حيث خرج في مجتمع قد غلب عليه الشرك ووسائله: كعبادة الأموات، وعمارة ما يسمى بالمشاهد برفع قبور الصالحين والأولياء، وبناء القباب عليها، وتحري الصلاة عندها، بالعكوف حولها، وبالذبح لها تعظيما واحتراما، وبإيقاد السرج عليها طوال الليل، وبالنذور، والهدايا إلى تلك الضرائح، وتعليق الرجاء عليها، والهتاف بأسماء الأموات، وندائهم ودعائهم مع الله، كقبر: شمسان، وتاج، ويوسف، وزيد بن الخطاب ونحوهم، فَبيّن لأهل زمانه أن حقهم علينا محبتهم واتباعهم، والعمل مثل أعمالهم، فأما الدعاء والرجاء والذبح والنذر، فهو خالص حق الله، وأورد لهم النصوص الصريحة في مصادمة ما فعلوه للتوحيد، كقوله -صلى الله عليه وسلم-  لعن الله من ذبح لغير الله
لعن الله من ذبح لغير الله 
 مع قوله تعالى:
مع قوله تعالى:  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  أي: خصَّه وحده بالصلاة والنحر، فمتى صلى أحد أو نحر لغير الله فقد أشركه في حق الله، وبين لهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فقال قبل أن يموت بخمس: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك
أي: خصَّه وحده بالصلاة والنحر، فمتى صلى أحد أو نحر لغير الله فقد أشركه في حق الله، وبين لهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فقال قبل أن يموت بخمس: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك  .
.
وقال وهو في سياق الموت:  لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
![رواه مسلم برقم (529) في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور... إلخ. عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم برقم [530 (20)] في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور... إلخ.](/site/books.png) يحذر ما صنعوا.
يحذر ما صنعوا.
وقال -صلى الله عليه وسلم- لعن الله زائرات القبوروالمتخذين عليها المساجد والسرج ودعا ربه فقال:  اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
 والمعنى: أن الأولين أشركوا؛ حيث تحروا الصلاة عند قبور الأولياء والأنبياء، فكل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجدٌ، لم يُبْنَ مسجد له منبر موجه إلى القبلة، فإن المسجد ما يتخذ للركوع والسجود فيه.
والمعنى: أن الأولين أشركوا؛ حيث تحروا الصلاة عند قبور الأولياء والأنبياء، فكل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجدٌ، لم يُبْنَ مسجد له منبر موجه إلى القبلة، فإن المسجد ما يتخذ للركوع والسجود فيه.
فأهل ذلك الزمان قد غلب عليهم قصد قبور الأولياء والصالحين ؛ للصلاة عندها، لاعتقاد أن للصلاة هناك مزية، وأنها أفضل من الصلاة في المساجد، ومع جماعة المسلمين، أو أن ذلك الولي يشفع في هذه الصلاة لتُقْبَل أو يضاعفَ ثوابها ونحو ذلك من الاعتقادات الفاسدة، ولا شك أن هذا تعظيم للمخلوق، ورفع لمنزلته إلى درجة لا يستحقها إلا الله.
فأما الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- فإننا نمجده ونحبه ونقدم محبته على الأنفس والأموال؛ فإنّ ذلك شرط لصحة الإيمان، لقوله -صلى الله عليه وسلم-  لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده والناس أجمعين
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده والناس أجمعين 
![رواه مسلم برقم [44 (70)] في الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. إلخ. عن أنس رضي الله عنه.](/site/books.png) ولكن لا نخرجه بهذه المحبة عن طبيعة البشر فنجعله ربا، أو إلها، أو خالقا، أو رازقا، وإنما ميزته الرسالة؛ حيث فضّله الله على جميع البشر، وأنزل عليه الوحي وكلفه بحمل الرسالة وتبليغها إلى جميع الناس، مع أنه لا يزال متصفـا بالبشرية وبالعبوديـة. قال الله تعالى:
ولكن لا نخرجه بهذه المحبة عن طبيعة البشر فنجعله ربا، أو إلها، أو خالقا، أو رازقا، وإنما ميزته الرسالة؛ حيث فضّله الله على جميع البشر، وأنزل عليه الوحي وكلفه بحمل الرسالة وتبليغها إلى جميع الناس، مع أنه لا يزال متصفـا بالبشرية وبالعبوديـة. قال الله تعالى:  قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ  بل إن الرسل كلهم لم يخرجوا عن وصف البشرية كما حكى الله عن الرسل قولهم لأممهم:
بل إن الرسل كلهم لم يخرجوا عن وصف البشرية كما حكى الله عن الرسل قولهم لأممهم:  إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  ولما تعنَّت بعض المشركين وطلبوا منه بعض الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله، قال الله تعالى لـه:
ولما تعنَّت بعض المشركين وطلبوا منه بعض الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله، قال الله تعالى لـه:  قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا  .
.
فهل من دليل يفيد أن الرسل خرجوا عن طبيعة البشرية، فصاروا يعلمون الغيب ويملكون التصرف في الكون، ويشاركون الرب في الإعطاء والمنع، والضر والنفع، ونحو ذلك.
أليس قد قال الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم-  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ  .
.
بل أمره الله تعالى أن ينفي عن نفسـه هذه الأمـور؛ حيث قال تعالى:  قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ  .
.
بل قد وصفه الله تعالى بالعبودية التي هي تمام التذلل والخضوع للرب -عز وجل- فقال تعالى في مقام التحدي:  وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ  وقال تعالى في مقام الإسراء:
وقال تعالى في مقام الإسراء:  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى  وقال تعالى في مقام الدعوة:
وقال تعالى في مقام الدعوة:  وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا  وقال تعالى:
وقال تعالى:  الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ
الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ  وقال:
وقال:  تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  .
.
فذكر تعالى أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- ومميزاته أن أنزل عليه هذا الكتاب، الذي أعجز الناس أن يعارضوه، ومن خصائصه -صلى الله عليه وسلم- ومميزاته أن أسرى ببدنه وروحه إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء إلى حيث شاء الله، ومن فضائله أن كلفه ربه بالدعوة إلى الله، وكل هذه المميزات لم تخرجه عن وصف العبودية لله بكل معانيها من كونه مملوكا للرب، ومن كونه ذليلا متواضعا وخاضعا له مطيعا، وهذا وصف فضل وشرف اتصف به المصطفَون من عباد الله، ولم يتكبروا عنه، قال تعالى:  لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ  .
.
فنحن نقول: لا يصح في تمجيد الرسول -صلى الله عليه وسلم- اعتقاد أنه خرج عن كل وصف البشرية، إلى وصف الملكية، أو إلى وصف الربوبية، أو الألوهية، ولا واسطة بينهما.